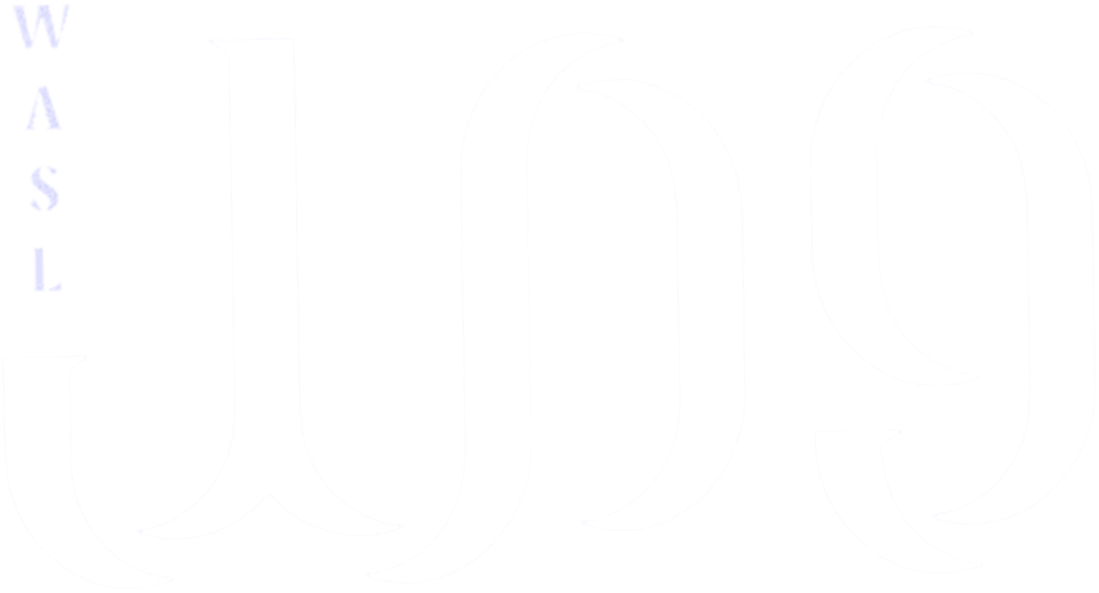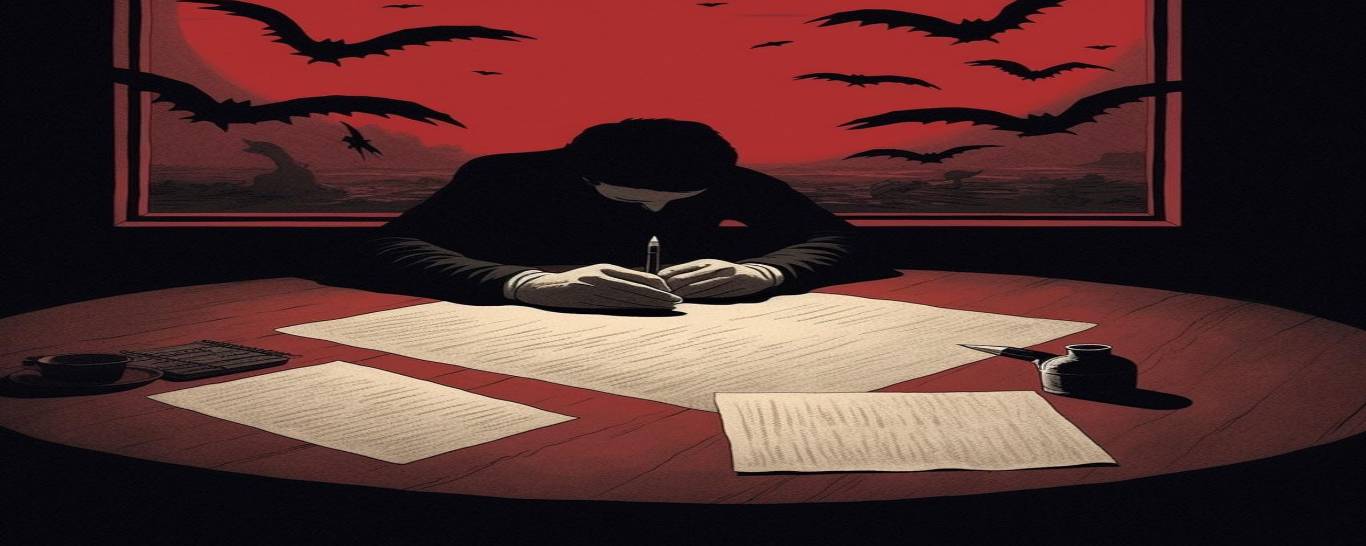حكاية الغرفة الضيّقة
في عليّة المنزل غرفة مُهملة، غرفة مهملة وضيّقة لا تصلح للبكاء، ولا تصلح للحب، ولا تصلح للمؤتمرات، في الغرفة الضيّقة استطعت أن أنعزل، وأن أقرأ وأن أكتب على جدرانها وصيّةً خالدةً للأرواح، في تلك الغرفة الضيقة؛ سجادةٌ تصلح للافتراش نومًا وجلوسًا، ذات لون واحد، وبسطح مستوٍ، لم تُمرَّر عليها أي أداة لصناعة خنادق أو إنشاء بروزات تجميليّة، في الغرفة الضيّقة والممتلئة بالأرفف حتى سقفها، قد تسرق السجادة الملوّنة الأنظار عن ورق الكتب ذي اللون الواحد، وتُلهي عن اعتكاف المطالعة، لذلك كان هناك سجادة رماديّة، وأرففًا خشبية، وحدها أغلقة الكتب، كانت تسطع بألوانها الفاقعة من فوق الجدران.
في الغرفة الضيِّقة تتسلّق الأرفف بعضها بعضًا، تتعرّش على حوّافها الحروف والكلمات المتسرّبة من أوراقها، تُبقّع الخشب بلون أزرق داكن، وتتفشى على ورق الجدران في الزوايا بين الرفِّ وحائط الغرفة في محاولات هروب فاشلة، تُجيد كلمات الكتب الإقناع، وبيع المشاعر المؤقتة، وجمع تأييد الرعاع، وكُنت أنا أحب هذه اللعبة، أقرأ الكتاب في جولة للمقارعة بيني وبين حبره، ولا أعلم أيّ منّا يفوز في كل جولة، لأني دائمًا أغفو فوق السجادة، مغلقة الكتاب بين يديّ حتى لا تتسرّب الكلمات خارجه، وتفسد لون سجادتي الواحد.
في الغرفة الضيّقة فتحة سقف تفضي إلى السماء، تتيح لأشعّة الشمس أن تدخل متى شاءت، ولماء المطر أن يطرق زجاجها كيفما شاء، وحدها الفتحة السماويّة تصل الغرفة بالعالم خارجها، لا نوافذ في الجدران لأن الأرفف تتسلق بعضها البعض، ونافذةٌ في الجدار تهدر مساحة للتسلق، لذلك كانت الغرفة أربعة جدران لا أعلم لونها، وباب في منتصف الجدار ناحية الجنوب، وفتحة للسماء في منتصف السقف، وسجادة لم تبقّعها قطرات الحبر الداكن، لا شيء ينير الغرفة سوى أغلفة الكتب الفاقعة، وأحيانًا شمس الظهيرة إذا توسطت الشمسُ سماءها، غرفة ضيّقة في المساء لقلّة منفذ الضوء، وضيّقة في الصباح لاتساع العالم عنها.
في الغرفة الضيّقة لم أستنشق سوى العطن النابع عن الورق المتكدّس فوق بعضه، ورائحة الشمس على السجاد المغبر، والحبر المصطبغ على حوافّ الأرفف، في مكان يدخل إليه الهواء والضوء دون إذن من الفُتحة، كنت هناك كل يوم أعبر من فضاء إلى آخر، بعينين متوقّدتين، وشفاهٍ مترقّبة لتصطاد الكلمات من صفحات الكتب، فضاء واسع في الداخل جهلت كنهه لمدة من الزمن، في ذلك الفضاء، أو الفضاءات بالأحرى، المتراكمة فوق بعضها، كانت في المسافة بين كل كتابٍ ورفيقه، وبين كل صفحة ومثيلتها، أحسسته فضاءً لاسعَ البرودةِ حين رفعتُ رأسي أنظر الفُتحة، فانعكست على مُقلتيّ كل تلك الأشكال الغريبة الراكنة فوق الأرفف، ظلالٌ تسبح في الفضاء بجانب الجدران، حينها فقط، انتبهت إلى المسافة بين أعلى خزائن الكتب وبين السقف، لم ألحظها من قبل لأن الظلال كانت تسكن هناك، مؤطّرة سقفَ الغرفة بلون أسود، لم أجرؤ على الحركة لبرهة، لكنّ الكتاب بين يديّ يزداد برودة ما لم أحرّك صفحاته، أنزلت رأسي على مضَضٍ، ومع حركة شفتيّ على وقع الأحرف التي تراها عيناي، نسيتُ أمر الظلال، وربّما نسيَت الظلال أمري، فتركت الزوايا وعادت تسبح في حلقات حول الفُتحة السماويّة ولا تقترب منها.
لم يكن الحبر المُبقّع في عدّة أماكن إلا محاولات الظلال في تهريب الحكايات من الكتب، وكنت قد ظننت أن الكلمات تتفلّت من رباطها الورقي، حتى أمسكت بظلّ نحيلٍ، أو هكذا رأيت شكله، قد ملأ كفّيه بالحبر من كتاب لم أفتحه منذ مدة طويلة، لكن الظل عجز عن الطيران في فضائه لثقل الحبر في يديه فراح يتسلّق، والحبر تسرّب من يديه وبقّع الرف، حتى إذا وصل إلى مسكنه في المسافة بين الرف الأخير والسقف لم يعرف كيف يصل إلى فُتحة السماء دون أن يطير، فعاد أدراجه يعيد الكلمات إلى سجنها. في اليوم التالي، توجّهت إلى الكتاب الذي كان ضحيّة السرقة بالأمس، أو هدف التحرير، بحسب ما إن كنت ظلًا يفاخر أفعاله أو ساكنة تندبُ أملاكها، وهناك وجدت الكلمات خفيفة الحبر، ولم أتذكّر ما إن كنت قد اشتريت الكتاب من مطبعة مزوِّرة، أو أن الظل قد أخذ، أو حرر، شيئًا من الحكاية!
على سقف الغرفة سكنت ظلالُ الكتب، تُعاود محاولاتها في تهريب الحكايات مرّة بعد مرّة عبثًا، وتابعتُ حركتها من طرْف عيني مرّة بعد مرّة، متّكئة بظهري إلى الباب في الجدار الجنوبي أقرأ كتابًا كان ضحيّة سرقة في أمسٍ قد مضى، أو مستلقية فوق سجّادتي أُطالع فتحة السماء، حينها تذكّرت أن الظلال لا مادّة لها، وأن بوسعها اختراق الجدار، لم أعرف إن كان عليَّ قول ذلك بصوتٍ عالٍ ليسمعني الظلُّ النازل درجات الأرفف يوازن الحبر في راحة يديه، أم أن الظلال يمكنها قراءة ما يدور في خُلدي، ربّما نَسيت الظلال أنها ظِلالًا، وظنّت أنها لا تزال من لحمٍ ودم لما كانت تكتب! في كِلتا الحالتين فضّلت أن أصمت، أراقب أكثر، وأقرأ وسط الظلال أكثر.
في الغرفة الضيّقة والممتلئة بالظلال لا يسكتُ صوت ولا تهدأ حركة، وجدَت أصوات الغرفة منفذها إلى مسامعي بعد أن اعتادت عليَّ، مُفترشة منتصف السجادة مثل كل مرّة، حانية ظهري إلى كتابي، أغمغم بما تلتقطه عيناي من حبر، والأصوات في فضاءات الغرفة لا تهدأ، نقرة بقعة الحبر إذ تسرّبت، تقليب صفحات في محاولة عبثيّة أخرى للهرب بالحكايات، وقع خطوات واصطفاق هواء بفعل حركة عجلى، نامت رجلي بعد أن تربّعت طويلًا، وخفّ وزني لمّا انغمست في الحكاية في حِجري، حينها انفلت ظلّي عنّي، وراح يترنّح بلا توقّف، يأخذ خطوة إثر خطوة بحسب إيقاع ما يسمعه، يراقص ظلًا سئم محاولاته العابثة..
"زوربا؟" خرجت من شفتاي صوتًا مسموعًا؛
حينها عاد ظلّي يتشبّث بأطرافي، وعاد الظلّ إلى زاويته بين الرف الأخير والسقف، وسكتت الأصوات وهدأت الحركة، وكنت وحدي هناك في الفضاء الصامت، منابت شعري باردة جرّاء عرقي المتصبب، أمد ساقاي بعد أن استفقت من غمسة روحيّة، بيدي كتابٌ خسرتُ حبرَ صفحاته الأخيرة، وتفلّتت من وعيي أول حكايته لما لم أستطع إتمامها، لم يتبقّ من اليوم شيء لإتمامه أيضًا، أعدت الكتاب إلى رفّه، وخرجت من الباب أتساءل لِمَ لَمْ أنظر إلى غلاف الكتاب لأتذكر قصّته!
في الغرفة الممتلئة بالكتب والظلال، لا يُفترض بالأصداء أن تتردد، وحده فضاءٌ فارغ يجيد تلقّف الأحاديث، لكن الغرفة الممتلئة تعبأت بالفراغات حتى أُتخمت، أربعة جدران تمتلئ بالكتب، وأنا في المنتصف أسفل فتحة السقف دائمًا، كلمات وأجزاء الحكايات تصبّغ حبرها على حوافّ الأرفف جرّاء محاولات التهريب، ظلالٌ تسكن أسقف الرفوف، فراغات متناهية الصغر بين كتاب وآخر، كان كل ذلك كفيل بخلق أبعاد تتمدد في فضاءات لا متناهية، فضاءات تتسع لكل الترَّهات، الهواجس، والتخيلات، والهلوسات.
تتسع الغرفة على ضيقها لشخصين، ثلاثة، أربعة، ربما أكثر من ذلك أو أقل، يعتمد الأمر إلى أي مدى يتسع خاطري، ومدى رحابة أغلفة كتبي لتضيء لنا مساءاتنا، وإلى أي مدى يمكن لظلّي أن يتمسّك بي، ولشعري أن يمتص قطرات عرقي البارد، ولنافذة الغرفة أن تحتمل ضغط إنعاش كائنات اللحم والدم المتزايدة على غير العادة.
كان قد زارني صديقٌ لي مؤخرًا، تختفي أصوات الورق والنقر حين يزورني أحدٌ، وتتلقّف فراغات الغرفة همهماتٍ تنفلت من بين أسناننا بفعل القراءة، هواءٌ زائد نُخرجه، وطرقات ناعمة لشفاهنا، ولزوجة اللعاب بين كل ضمّة شفتين وفُرجة إذا تجمّع من شدّة العطش والجفاف، لا يُسمح بالأكل داخل الغرفة، قانون شعرت بقداسته منذ دخولي الأول إليها، لكنّ مع زياراتٍ بين حين وأخرى أسمح لرائحة الشاي والقهوة، بحسب تفضيلات أصدقائي، أن تقارع روائح الغبار والحبر والشمس على السجادة. حينما يجالسني أحد في غرفتي الضيقة، تظهر متسعة بشكل ما، يستند كل منّا على ظهر الآخر، ونمد ساقينا تجاه الأرفف، ونطالع حتى تنام رجل أحدنا، فلا تتوقّد عقولنا أكثر، أو يتفلّت ظلّ، فلا تعي قلوبنا بفعل الرعب، حينها فقط؛ نعلم أن الغرفة قد ضاقت على زائرها، فنخرج معًا يتأبّط أحدنا ذراع الآخر، أوصل زائري إلى باب الدار، وأعود وحيدة داخل الغرفة، أطالع الظلال في الزوايا المرتفعة، أغلق نافذة السماء رغم أن ظلال الغرفة لن تستخدمها للهرب، وأرقد على ظهري بضع دقائق، أستمع إلى صوت الورق والنقر يتعالى تدريجيًا حتى يصل إلى مسمعي، ثم أخرج، لأعود في الصباح.
في ذلك الصباح، لم تكن الغرفة في العليّة! وجدت الباب في الجدار الجنوبيّ مفتوحًا على غير العادة، وفضاءات الغرفة اللامتناهية قد باتت واحدة، تعبأت على إثر فضاءها الجديد بالغبار والغبار وحده، لا غبار ورق، ولا أغلفة فاقعة الألوان، ولا أرفف مصطبغة ببقع الحبر تصل إلى السقف، وحده غبار الأشياء القديمة والمهملة قد عطّن المكان.
"كُنت هنا البارحة برفقة صديق!!"
لكن من كان هذا الصديق؟ لم أجرؤ على نطق الكلمات لسببٍ ما، لا أذكر وجهه، ولا اسمه، قرأنا معًا ليلة البارحة شيئًا حول الحب، وشيئًا حول الخيانة، شيء ما يدفعني للإيمان بعلاقة ما قرأته الليلة الماضية باختفاء مكتبتي القديمة، هل نجحت الظلال في الهرب؟ كنت قد أغلقت الفُتحة! لا شيء من أفكاري يقودني إلى إجابة، جلست في المنتصف أحاول استعادة ما اختفى، أحاول استدعاء خيالٍ ما، أو فيضٍ من عقلٍ ما، حتّى توارت الشمس إلى مغيبها، وتسلل شعاعها المشتعل إلى وجهي يؤذي عينيّ، غادرت الغرفة بوقع أقدامٍ ليس مسموعًا لأحد، ولحظة أغلقت الباب خلفي تذكّرت، لم يُزعجني يومًا مغيب الشمس، جبُنت في سرّي أن أعود وأتفقّد فُتحة السماء.
في غرفة النوم الواسعة لا مكان لوضع خزانة كُتب، أو تعليق أرفف في الجدار، تمتلئ الغرفة بورق الجدران الأبيض، ولون آخر لا أعرفه، في منتصف الغرفة طاولة لشخصين، وكرسيّ أطفال، يمتلئ سقف الغرفة بأضواء كهربائية، تمنع الليل عن سكونه والنهار عن حيويّته، لا حدَّ يأتي بالتعاقب المستمر لهما، ورغم اتساع النافذة، وبروز شرفتها، إلا أنها مُغلقة دائمًا، لئلا يتسرّب إلى الداخل هواء الخارج حاملًا رائحة الشمس، فيفسد على الغرفة عطرها النفّاذ، خالقًا حقلًا من ياسمين ليس موجودًا، لا أصواتَ خافتة توسّع فضاءها الضيّق، إذ لا مكان في الغرفة الواسعة سوى للأحاديث الصاخبة، الممتلئة بالضحكات وقرقعات بذور دوّار الشمس بين الثنايا، لا أصداء تتردد داخل الغرفة، فلا مكان لتُعشعش فيه الفراغاتُ مُنشأة أبعادًا وفضاءات متعددة، في الغرفة الواسعة، أجلس على طرف سرير الريش، تحكّني منامتي الحريرية، أهمهم بترانيم لا أفهمها، ويُلاحق بؤبؤاي رسومات حبر لا مرئية، أحاول استدعاء ظلالٍ تراقصُ ظلّي المختبئ تحت السرير، متواريًا بذعره من شموس تُعمي عليه نور الليل القاتم.
في غرفتي الواسعة الجديدة، لم أعِش إلا حياة واحدة مملة، وتفلّتت منّي كل الحيوات التي قرأتها تحت الفُتحة، تعاقب عليّ وقتٌ حسبته بنموّ شعري وأظفاري، وكلما قصصت من شعري أكثر، خسرت من ذكرياتي أكثر، حتى أني لم أصعد العليّة منذ أن أزعجني شعاع الغروب لأول مرّة، لكن اليوم، يومٌ أجهل زمانه، أمسكت قلمًا لأول مرّة، وصعدت العليّة بدواة مملوءة بحبر أزرق داكن لا يتفشّى على ورق الجدران، لأكتب فوق الجدار الجنوبي قصة الغرفة الضيّقة التي كانت موجودة يومًا ما، بعَطَن ورقها المُكدّس، وظلالها الراقصة والسارقة، غرفة ضيّقة جدًا اتسعت لي، واتسعت لكل الأرواح المركونة على الأرفف، ثمّ خبت للأبد.