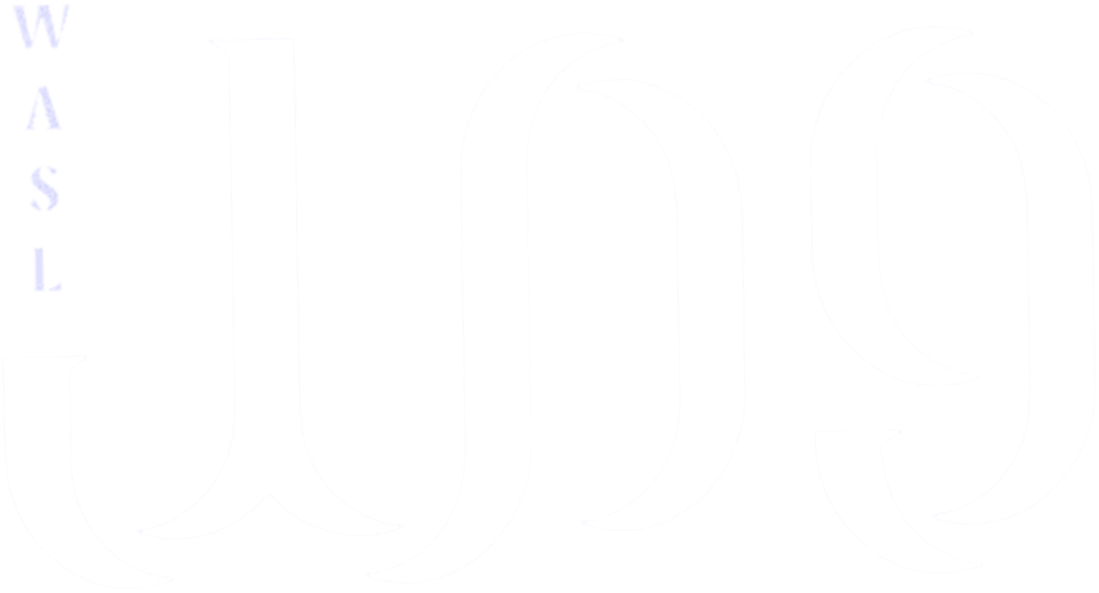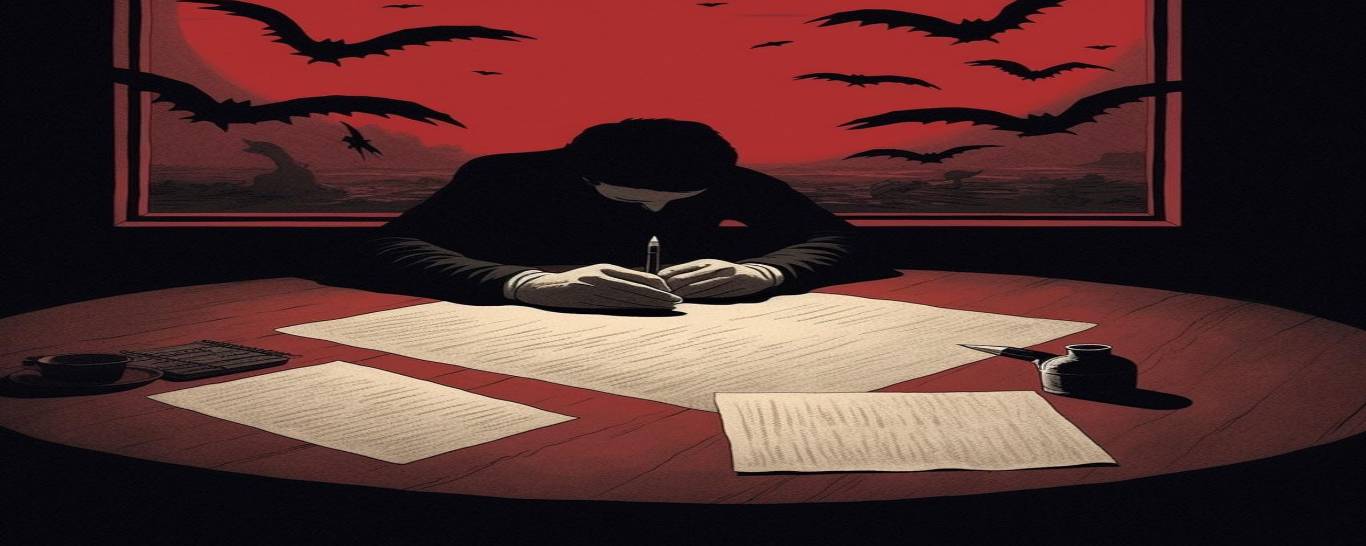حضنٌ عريق
للأماكنِ سُطوةٌ، ولبعضها عبقٌ؛ قلَّما تقاومه الأرواح، وإن قاومته العقول وأصحابها.
لها أثيرٌ يخترق خلاياك، وبها مخالب من شعور، تُحْكم قبضتها عليك كلما مكثت فيها أكثر، وإن لبثت عنها زمنًا؛ تظل تعيد وهج الذكرى؛ لتنبض فيك مرات ومرات، حينها لا تهم جودة تلك الأماكن ولا حتى فخامتها، فقيمتها تجرَّدت من كل الأمور المادية، وحلَّقت في عوالمٍ خفية، تأبى عقولنا الإحاطة بها، أو استيعابها!
ستعلق فيك مهما كانت، ثم تحتاج معها إلى إعادة برمجة، لتخرج نفسك من براثنها إن استطعت، ومهما ادَّعيت أنك استطبت عنها، تنبُشك لمحة أو نفحة أو حتى قشة؛ لتُهيّج فيك الركام من جديد!
في جولةٍ على ديار المعمورة ستجد "الحضن العريق" الذي استحلَّ المساحة الأعظم من ذاكرتي وخلاياي، هو بينها الأدفأ، وعلى أطهرِ ثَرَى الأرض هو لنا المرفأ، في "جرول"(1) واحدة من أقدم حواريها، وعلى ناصيةِ شِعابها ومفترق ضواحيها، تلفُّه الضوضاء من كلِّ نواحيهِ، وتحتضنه عراقة الطين، وتكسوهُ جاذبية الرواشين، لا يلفتُ نظرك إلا بهَامَتِهِ القائمة بين تعرُّجاتِ جَبَلٍ، كيف استقام؟ وكيف استحال الصخرُ مهدًا لجلاله النابض بجلال قاطنيه؟
بل جلال "جدتي" صاحبة المركاز فيه، وعمدة البناء الأولى والأخيرة.
يستقبلك على اليمين زقاق عشوائي، يتوسطه -أو هكذا أحسب- باب أخضر حديدي، تفوح منه رائحة الماضي، وتئن من فواصله وعثاء السنين، ليشرَع على فناءٍ ممتدٍ ضيقٍ، يتسع في آخره، ثم يجبرك على الانعطاف يسارًا، لتقابلك دكة مرتفعة على يمينه، جمعت على بلاطاتها جنون الأجيال، وصخب مختلف الأعمار، تربط ضجيج الخارج بالداخل، فترسم لك سيمفونية احتجاج على هدوء التحول، وصمت التغيير.
ثم أمامك باب آخر، بلون مغاير، لا أعلم إن كان الأمر مُدرَكًا من قبل بانيه، عن اختلال التمازج وتنافر المحصلة أقصد، أم أنه محض هراء لا يُؤبه به؛ فالعمق خلفه يحوي الكثير الأهم!
وما أن تفتح الباب شاذ الشكل واللون؛ حتى تدخل إلى عالمٍ غير العالم، من زمنٍ غير الزمن، وبناسٍ تحنطوا بآمالهم، وأحلامهم، وحتى أفكارهم، وشكْل معيشتهم، على وقتٍ غابر، لا يحاكي الحاضر من قريب، ولا حتى من بعيد.
سترقى درجتين، وتُوجِّه وجهك شمالًا، فتقع عيناك على أعظم ممر في تاريخ الذكريات، مُظلمٌ إلا من عمود إنارة يتوهج في سقفه، وبسبب طوله الفارع عجز عن إضفاء النور عليه، له رائحة القِدَم، دهكته خطوات العجز والحرمان، ثم غمرته صرخات الطفولة في مقاومة للفَنَاء السابق أوانه.
في آخر الممر؛ وعلى يمينه؛ تجد بابين، بمواصفات لن تتكرر، لا في بقية البناء، ولا في سائر أبواب الحياة على الإطلاق، محكمة الإغلاق طوال العام، حتى لو احتشد خلفها الناس، ستبقى، برتاجة وقفل مفتاح مرتين، مع ضرورة رفع المفتاح من مكانه إمعانًا في الإحكام.
بابٌ خلف بابٍ خلف بابٍ خلف بابٍ، وكأنك في حملة اقتحام لمعتقل أمني، لكنك لست إلا في طريقك لبيت ستي!
والتي لم يكْفها أمان الأبواب المة، ولا إحكام القفل المرجو، بل صارت دارها عصية على زائريها -غير المرغوب فيهم- بعدما أحالت أُطُرَ أبوابها الخشبية لأخرى حديدية، لتقف منيعة أمام هجمات الأرضة ( 2) المتوالية، والتي اكتسبت مناعة ضد محاليل القضاء عليها، فلم تجد بُدًّا من تحويل طعامهم المُشْتَهى إلى آخر صعب المنال، لا رائحة له تجذبهم، ولا لون يغريهم، ولا مرونة تستهويهم.
عتبات الباب أيضًا لم تسلم من خططها العبقرية، فزادت طولها لدرجة صرت تحتاج معها إلى أخرى أمامها لتتمكن من اجتيازها!
كل هذا في سبيل منع الفئران من اقتحام مساحات المنزل المُحصّن بالكامل، حتى مجاري المياه فيه؛ سُدَّت بجوالين الماء الفارغة، وجوالين سائل التبييض بعدما أفرغتها منه واستبدلتها بالتراب والحصى لتزداد ثقلًا ومناعة أمامهم.
عبقرية تلك التفاصيل، والتي ساعدتها في الاطمئنان إلى أمانه، المزعوم أو المؤقت، لأنه لم يستمر طويلًا بعد أن وجدت تلك الكائنات الكريهة منافذ أخرى للاقتحام لم تخطر على بال جدتي بعد!
وعلى الرغم من ذلك؛ ظلَّ المنزل محصّنًا منيعًا إلى حدٍّ طويل، إلا من ذرات الغبار المتكاثر فيه، المتكثف على جدرانه وأثاثه، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ منه، مهما بذلت جهدك لمكافحته فهو عالق، أو ربما صار مكوِّنًا أساسيًا من المنزل، لدرجة تحتار فيه بين من صاحب الدار ومن الدخيل منهم! حتى بات المعتاد لمن يحاول المبيت فيه التهاب جيوب أنفية مزمن، طوال مدة الإقامة، وقد تمتد لأيام بعدها!
كل تلك العيوب لم تُخِّل ولو لدرجة من روحانية الدار، ولا من حشد الذكريات المتكدسة في جنباته، هناك وسادة حضنت دموع الوحدة ومرارة الشوق، أو ربما دموع الرشح وقطرات السعال، وهناك جدار يشهد لك خلاياه بكل الجرائم التي شهدها ضدك، في محاولة منك لإعادة لونه الأصلي بمختلف أنواع المنظفات والتي باءت كلها بالفشل، وهناك ركن ضيق جُمعت فيه الأرواح، وحلّقت فيه المشاعر إلى حدٍّ لم تبلغها في سواه، وزاوية تنامت فيها الخفقات، وتصاعدت معها الأنفاس، بعد ذكر أو دعاء تردد على لسان صاحبة الدار "ستي"(3).
ثم هناك مساحات التخزين والتي تفوق عدد ساكني الدار وغرَفِهِ، مكتبة في كل غرفة، وأدراج موزعة في كل زاوية، تضم في كل واحد منها فوضى في مرأى الجميع إلا في عيون جدتي، فكل درج جمع أغراضها بعناية فائقة؛ أرقام هاتفٍ بعضها في كرّاس وأخرى مبعثرة، منقطة بخط يدها وبألوان حبر مختلفة لتميز بينها، فجدتي لا تقرأ ولا تكتب، ولكن لفرط ذكائها استخدمت طريقة التنقيط لتقابل كل رقم بعدد نقاط يساويه، أما الصفر فعبرت عنه بخط طويل عكست معه المألوف، وخرقت العرف والعلم والعادة!
درجٌ آخر حوى مقصاتٍ وعدة خياطة، وثالث فيه نسخ مفاتيح بألوان وأحجام مختلفة ورائحة موحدة لا تنفك عن يديك إن فكرت في لمس أحدها، والقائمة تطول دون حصر عدد الأدراج ونوع فوضاها!
على يسار مدخل البيت؛ باب غرفة المعيشة وأحيانًا غرفة النوم، ولها فيها مآرب أخرى، تَحنّطَ على حائط أمامها دولاب خشبي، جمعت أغراضه باحترافية بالغة، يضم بين أرففه بضع كراتين لمراهم عضلات من شركات مختلفة، بتوصيات منمقة من الأهل والأحباب، أصبع فِكس للأنف، وعلبة فِكس لكل داء مهما بلغت شدته، فالوصفة السحرية للشفاء عند جدتي: دهان بفكس ومص حبة بنادول مع ضرورة التأكيد على وضعها تحت اللسان إلى أن تذوب بالكامل، لأنك لو ابتلعتها مباشرة لن تجدي معك نفعًا! والخيار عندك، وإياك والشكوى بعدها.
فيه أيضًا مؤونة من علب فيتامينات نفس النوع ونفس الشركة، ربطة شاش، ولصقات جروح، و"مكركروم"(4)، وفوار فيتامين (ج)، وإن كنت محظوظًا ستجد لصقات جونسون(5)، أما أدويتها الثمينة اليومية ففي حقيبة سوداء لا تفارقها، بها مرهم عضلات للاستخدام اليومي، زجاجة فيتامينات متعددة، وكرتون دواء المعدة والذي تحرص على وجوده ووجود بديل له متاح على الدوام.
في كل غرفة جهاز هاتف من نوع منقرض، بقرص أرقام عليك أن تديره لآخره حتى تصل لرقم 9 لا يُشترى لأنه لا يباع، فهو منحة من شركة الاتصالات مع كل خط منها.
من ضروريات المكان أيضًا، رفيق جدتي الليلي؛ مسجلٌ يعمل بالكهرباء وبالبطارية للاحتياط، في دوام رسمي يومي له قبل النوم لتدير عليه سور الرحمن ويس وتبارك بصوت القارئ السديس، وفي كل مسجل نسخة منفصلة لنفس السور بنفس الصوت. ثم في كل المنزل جهاز تلفاز يتيم، لا يدار إلا على قناة السعودية الأولى لمتابعة بث صلوات اليوم الخمس، والويل لمن تجرأ وغير المحطة.
مقابل الغرفة متعددة الاستعمالات باب المطبخ، والذي لفرط صغره؛ طرد الثلاجة منه إلى ممر أمامه، واكتفى بصف دواليب، تشهد صحونها وأكوابها على كهولته وأصالته في آن.
لا يكاد يخلو في كل مرة زرته من علب الشاي، والنعناع المجفف، وأعواد البقسماط، فأنت إن كنت في ضيافة جدتي لأيام؛ ستشهد أمعاؤك استجمامًا إجباريًا لا مثيل له، تتقلص وجباتك إلى بيضٍ وجُبنٍ، وللرفاهية قد يستحيل البيض شكشوكة(6) كواحدة من أصنافه الفاخرة.
إلَّا إن كنت تستطيع الطبخ؛ وإلا فارضَ بالمقسوم حتى تحن عليك صحتها لتُعدَّ لك وجبة طعام مطبوخ لا يمكن أن تنسى حواسك لذة نكهتها، لتعلق فيك مهما سارت بك الحياة.
منزل جدتي الرسمي في مكة، ولكنها تسكن أحيانا مع أمي ابنتها الوحيدة، في مدينة جدة، لمدةٍ وجيزةٍ لا تتجاوز الشهر، لتعود إلى بيتها ومِلؤها الشوق، وإن ظلت فيه -بمفردها- معظم الأيام.
إن هاتفتها في أي يوم من أيام وحدتها لتستعلم عن حالها سائلًا: من معك ياستي؟ أتتك إجابتها الحاسمة في كل مرة: ربك خير كل أحد، آنسَتها مخادع المنزل الخاوية، وأنعَشت فؤادها جيرة بيت الله الحرام، فاستغنت بصاحبِه عن جيرة عبيده.
نتسابق على صحبتها حسب أعمارنا وأوقات فراغنا، فمن يفرغ أولًا من ارتباطاته في جدة -دراسة أو عمل- ينتقل إلى مكة ليعتكف في دراها ما استطاع لذلك أيامًا، لتُحسب عليه أسعد أيامه، بما فيها من تقشف، ورجوع بالزمن، وفقدان لملذات الحياة الأساسية، إلا أن لها رونقًا وتألُّقًا لا تنافسهما عليه أي ملذات أخرى.
ثم تلحق به بقية أفراد العائلة في عطلة استجمام كل نهاية أسبوع، في ظاهرها استجمام إلا أنها في الحقيقة أشغال شاقة مع محاولات بائسة في نتيجتها، مرضية في ظاهرها لجدتي، لمحو آثار الهجر والزمن من أركان بيتها.
فوالدتي وهي وحيدة جدتي مكلفة بالقيام بمهام تعزيل الدار ركنًا ركنًا، في كل زيارة، مما عُدَّ أمرًا مفروغًا منه لا رجعة فيه. تمضي بمعداتها، وغطاء رأسها، وكمام أنفها، في مهمة تتكرر، وكأنها تتم لأول مرة في كل مرة، يصاحبها رشح مدوٍّ، ونوبات سعال خانقة، كنوعٍ من أنواع مقاومة الغبار البائسة.
ثم تنتهي وكأن شيئا لم يكن، فالحال على ما كان عليه؛ إلا ملامح جدتي المكسوة بالرضا والحبور، لتكافئ الجميع بطريقتها، وكلٌّ حسب اجتهاده.
حمراء أو خضراء؟ (الحمراء كناية عن النقود من فئة 100 ريال، والخضراء 50 ريالًا) أما الزرقاء فلمقام الوالدة ولا أحد سواها (500 ريال(.
غنيمة في زمانها، من أعظم رمز للكرم والعطاء شهدته في حياتي، نتنافس على حيازة إعجابها بنا، لننال رضاها والإكرامية معًا، لأنها من نصيب المجتهد، وعلى قدر سعيك تنال نصيبك، وأعلى درجات السعي في حسابات جدتي هي قراءة قرآن من مصاحفها المعلقة على شبابيك كل غرفة، فأنت هنا فزت بلذة شعورها، وامتنانها العميق لكل من يقرأ أمامها من مصحف في دارها، ظنًّا منها أن المصاحف تُهجر بعدم القراءة، والسعيد من يغنم الثواب بالتلاوة.
هذا باختصار بيت جدتي.. قيل عن الحضن أنه الملاذ، والأمان، والحب، والاحتواء... وهكذا كان بيتها وأكثر، فالحضن دافئ؛ وبيت ستِّي أدفأ.
عقودٌ جمعتنا فيه، لتنتهي بعد أن غادرتها الذاكرة حياتها فيه، فتلبث في بيت ابنتها سنينًا، علقت بها الروح، متشبثة بعداد سنوات حياة محسوبة عليها، وإن فقدت فيها معنى الحياة، فغدَت طريحة الفراش، حبيسة الوهن، فقيدَة الإدراك، وسَرَقت منها الأيام نورها؛ وإن بقيت فيها نورًا.
فلم تعد تعرفُ الوجوه، ولا الأسماء، ولا الزمان ولا المكان، بعد أن كانت تعيش ملء كليهما..
خمسُ سنوات من التدهور، وكأنها الدهر، إلى أن اكتفت من الحياة، وأرهقتها الأيام، فاستسلمت للموت، وسلمت الروح لمالكها، وسلمتنا للبقاء أسرى أساطيرها؛ وكأنها لم تكن بيننا في يوم، وإنا على فراقها محزونون، حتى دارها "حضننا العريق" لم تلبث بعدها عتيّا، طالها الهدم، ودُكّت جنباتها، وكأنها هي الأخرى لم تكن إلا في بصيص ذكرياتٍ، يتشبث بنا، ونتشبث به أكثر.
إلى روح العظيمة جدتي "نور"
(1) جرول حارة مكيّة تاريخية، تقع في الشمال الغربي من المسجد الحرام، تحتوي على بئر طوى الذي مكث الرسول فيه واستحم من مائه لمدة ثلاثة أيام قبل التوجه لمكة في عام حجة الوداع وقد حوت العديد من عوائل مكة العريقة حتى وقت قريب… من كتاب قصة حياتي للدكتور صالح أحمد بن ناصر.
(2) في القاموس المحيط للفيروزآبادي الشيرازي، حرف الهمزة، (أرض): الأرضة دويبة تأكل الخشب.
(3) في اللهجة الحجازية تُشير كلمة "سِتّي" إلى الجدّة من جهة الأب أو من جهة الأمّ وهي لفظةٌ مُحوَّرةٌ عن كلمة "سيّدتي" لتسهيل المُناداة. ما معنى ستي وسيدي في اللهجة الحجازية؟ (arageek.com)
(4) مادة مطهرة ومعقمة، بنية أو حمراء اللون، تستخدم لتعقيم الجروح السطحية والخدوش.
(5) لصقة جونسون لآلام الظهر هي عبارة عن لصقة تتميز بقدرتها وفاعليتها في علاج آلام الظهر والعمود الفقري، وآلام الركبتين، والأكتاف وجميع آلام العضلات.
(6) الشكشوكة هو طبق من البيض المسلوق في صلصة الطماطم وزيت الزيتون والفلفل والبصل يقال أنها نشأت في شمال إفريقيا العثمانية في منتصف القرن السادس عشر بعد أن أدخل إرنان كورتيس الطماطم إلى المنطقة كجزء من التبادل الكولومبي.