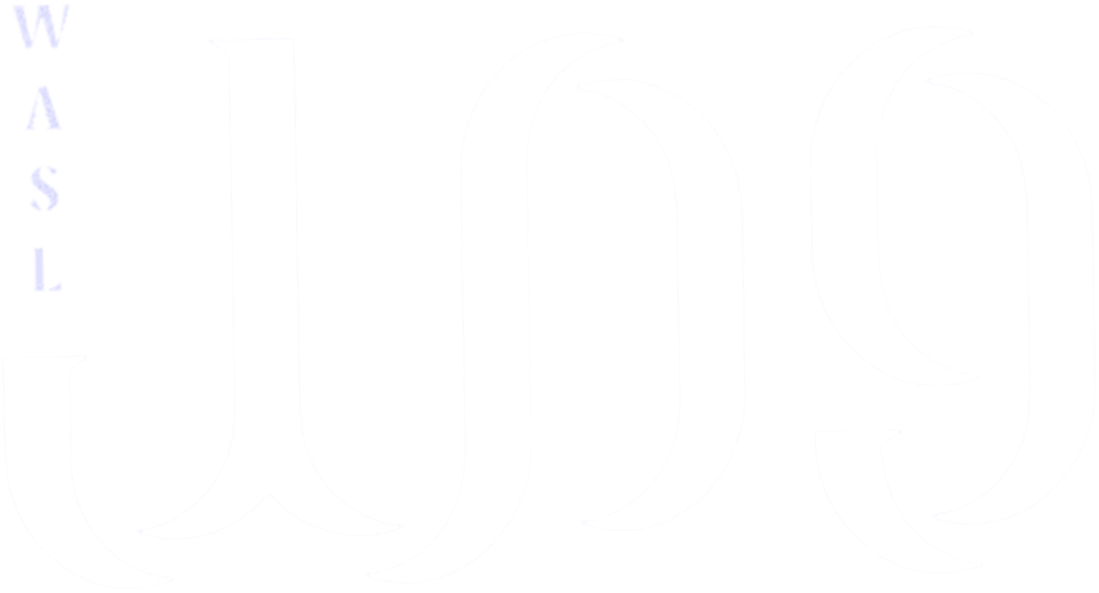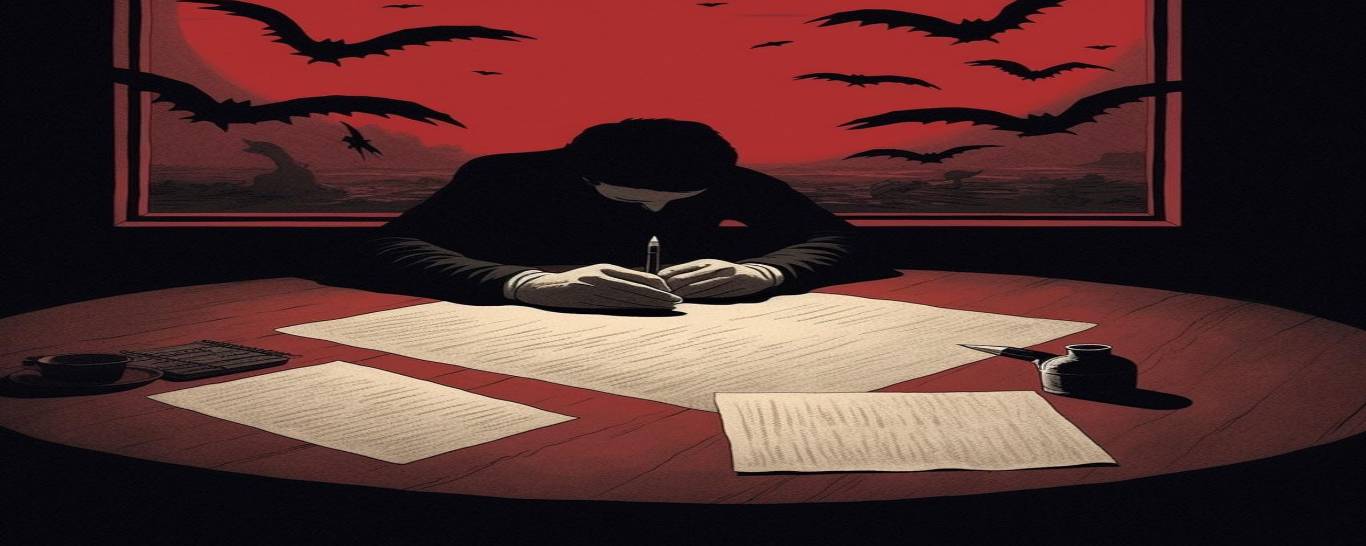بيت جدي للبيع
كان الخبر صاعِقًا، سرَى مثل كهرباءٍ مباغِتَةٍ لاسعةٍ في أجسادنا نحن الأحفاد الذين هاجروا لأسباب عديدة خارِجَ البلاد، كلُّ واحد منا في بلدٍ، مرَّت سنواتٌ عشر منذ غادر آخر فردٍ منا تاركًا مفتاح البيتِ في عُهدةِ الجارِ أبي محمود، لكن أبا محمود أصيب بالزهايمر وفقد عقله، وظل المفتاحُ معلَّقًا في علبة المفاتيحِ المعلقةِ هي الأخرى على الجدار مع مفاتيح كثيرة لبيوتٍ كثيرة هجرها أهلُها وسافروا هربًا من وعثاء الحربِ التي أنشبت أظفارَها في المدينة.
نزل خبرُ البيع مثل صاعقةٍ على البعضِ، فبيت جدي، هو الوطن باختصار!
كان البيت أشبه بقلعةٍ صغيرة، من طابقين وقبوٍ وحديقةٍ مزروعة بأشجار السروِ والعنب الزيتون والرمان، تتوسطها أرجوحة الدار الحديدية التي تحمَّلت مشاكساتنا وتنازعنا على مقعديها الخشبيين، ثم كَبُرت معنا وصارت تنصتُ لأحاديثِنا العميقة السرية، واعترافات الحُبِّ البريئة، ولم تُفشِ يومًا سرَّ أحد، بل كانت تهتز مع قلوبنا تتأرجح مستأنسةً بنا وبكل ما نقوله وما لا نقوله عندها.
حتى رَحَل الجميع، وبقيَت وحدها يأكلها الصدأ، ويغسلها المطر، وتجلدها الريح الباردة في مواسم الوِحدة التي لَم يقطعها شيء، شاخ كل شيء في (بيت جدي)، شاخت الأشجار، والأحجار والسور والحجرات والجدران، النوافِذُ والأبواب، ولم يعد أحدٌ ليعيد شيئا إلى ما كان عليه..
لكن الجميع ظل يحلم بالعودة، إنها أمنية الأعياد المتكررة، "سنجتمع مجدَّدا في بيت جدي"
لولا وفاة الجدِّ والجدَّة، وبعض أفراد العائلة قبل أن تتحقق الأمنية!
كلُّ شيء كان أثيرًا في "بيت جدي" إلا القبو.. كان مكانًا لا يريد معظمنا أن يتذكره، لقد وضعتُ أنا وأبناء عمي عدة خطط في الحقيقة لنزيله تمامًا من "بيت جدي" حين نكبر، سنردمه، سنقفله، سنبني جدارًا بيننا وبينه، ولن نخبر أحدا أن للبيت قبوًا مريعًا، لن يكون هناكَ عناكب ولا أشباح ولا عتمة مجددًا لهذا البيت، سنعمل جيدًا على اجتثاثه ودحرجته في أقرب حُفرة، سيكون بيت جدي حينها من طابقين رائعين وحديقة جميلة فقط، وسننسى القبو بكل ما حدث فيه، وما فيه من كائناتٍ مريعة، باختصار: سنقتله.
لكن خبر البيع الصادم جعلنا في هستيريا مجنونة، نتصل ببعضنا البعض نتداول الحلول لإيقاف هذه الفكرة التي أصبحت أمرًا واقعا لا مفر منه، كنا كمَن يبحث عن طفلٍ ضائعٍ، كمن يحاول إنقاذَ شيء ما من أن يغرق أو يحترق أو يتحطم، حتى أخذتُ قرارًا بالسفر إليه، فأنا دونًا عن الجميع، أريد أن أودعه، أريد أن ألقي نظرةً أخيرة عليه، ألملِم ما تبقى من الذكرياتِ، أبكي على كتفه، بل أقيم حفلة بكاءٍ تليق به، أحرق كلَّ الأمنيات التي علقتُها على سوره المحطم، كان قرارًا شجاعا جدًا؛ لأنني منذ أمدٍ طويل لم أسافر إليه..
"أنت شجاعة" هذا ما قالته لي بنت عمي (سلام) بعد أن تلقت الخبر: "هل ستذهبين إلى هناك! أنت شجاعة جدا"
لم أعرفني يومًا شجاعةً في شيء، أنا جبانة جدًا، خفتُ دائمًا من كلِّ شيء وأي شيء قد يهزُّ سكوني، ويؤثِّر على سكينتي وطمأنينتي، لم أتشجع إلا حين تزوجتُ، ثم تشجعتُ حين أنجبتُ، ولم أعرف الشجاعة في أي مضمار في حياتي، بل إنني من الذين يصابون بنوباتِ الهلَعِ من أشياء سخيفةٍ جدًا، خصوصًا ذلك (القبو)!
كانت الكلمةُ لا تشبهني في شيء، فالشجاعةُ بعيدة عني كلَّ البعدِ، ولكنني ربما خائفةٌ من شيء ما أكبر، خائفةٌ من أن أفقدَ (بيت جدي) للأبد..
الحنين أحيانًا يجعلكَ تقوم بأكثر الأفعالِ جنونًا، بشكلٍ يوحي بأنك شجاعٌ..
كنتُ أحن لبيت جدي، وللزمنِ الجميل الذي قضيناه فيه، أريد أن أعانق بحرارةٍ الزمان والمكان معًا، لمرةٍ قد تكون الأخيرة، علِّي أتمكن من التصالح مع فكرة (فقدهما للأبد).
كنت أريد أن أدخل حُجرةَ الكراكيب (المخزن) التي تقعُ أعلى الدرج، قبل الممر الذي يؤدي إلى القبو في الأسفل، أريد أن أفتح كل الصناديق التي هناك، أجمعَ كاسات الشرابِ التي كانت جدتي تحرص ألَّا نشرب فيها، كي لا نكسرها، وأجلبها معي، أبحث عن قصائد الميلاد التي كان يكتبها جدي كلما وُلد له حفيد، إنها في مكانٍ ما حتمًا.. سأفك ساقيَّ وأضعَ بدلًا منهما نابضي قفزٍ حيثُ أتجول في المكان قفزًا، وأنزل درج القبو الذي أهلع حين أقترب منه، ولكن هذه المرة قفزًا، كي لا يتسنَّى لي الانتباه لعناكب الزوايا النائمة، وأشباحِ القصص المرعبة المخزنة في ذاكرة الطفولةِ.
ذلك القبو، إنه ذلك الجزء القاتم من بيت جدي، عيبه الوحيد، أزمتنا التي سافرت معنا، وبَقِيت حكاياتها الصعبة تقض مضجعنا وتُفسد نومنا رغم البُعد.
يقولون إن عفريتةً تعيش فيه اسمُها (جلنار) لا يراها سوى عمي (مسعود) ولا تتكلم إلا معه، وهي تأكل من مخزون (المونة)(1) السنوي الذي تحفظه جدتي في القبو، الزيتون الأخضر وورق العنب والبامية والباذنجان وغيرها، لم تفتح جدتي إناء إلا ووجدته ناقِصًا بسبب (جلنار)، كانوا يخبروننا كيف كان شَعر (جلنار) طويلًا وأزرق اللون، وأنها كانت تصدر بعض الأصواتِ حين يكون الجميعُ نائما، يسمعه مَن في الحديقة في الجهة الجنوبية، لم تكن (جلنار) تؤذي أحدًا، لكنها كانت الشبحَ الذي اختلفنا دائما حول حقيقته!
حينها سألتها عن معنى (تُرَّهات) وأين قرَأَتْ هذه الكلمة الفصيحة جدًا؟ ولا أذكر جوابها آنذاك.
حسنًا؛ أنا أؤمن بالتُرَّهاتِ أحيانًا، أو إنني لا أؤمن بها، لكنها تجعلني في حيرةٍ من أمري، لا يمكنني التعامل مع القبو وكأنه مكانٌ جميلٌ يجلب الطمأنينة كالحديقة، إنه مكانٌ مريعٌ ورطب وباردٌ، تنفد إليه كل الأصوات من جدرانه الباردة، ومليء بالعثِّ والعناكب التي لا أفهم كيف تتكاثر!
تقول لي أمي: كل الأقبية هكذا، لا يمكن أن يخلو قبو واحد من العناكب، ثم إنها لا تفعل شيئا، إنها فقط تبني شبكاتها اللطيفة في الزوايا وتعيش.
حسنًا، لا أصدق أنني لمجردِ نيتي بزيارة بيت جدي، كأنني فتحت ذاكرتي وبدأت الذكرياتُ تنسكب أمامي، أتذكرها وكأنها حصلت بالأمس.
قالت لي سلام: "ما دُمتِ ستذهبين إلى هناك، أريدك أن تجلبي لي شيئًا خاصًا خبأته في القبو في آخر مرةٍ كنتُ فيها هناك؛
فصرختُ مذعورة: أين خبأتِه يا نور عيني، أفي القبو؟!
تضحك: أعلم أنك لا تحبين القبو، لكنه طلبي الوحيد.
ابتلعتُ ريقي.. وصرتُ أحاولَ تقبلَ الفكرة، وسألتها ثانية:
- ولكن ما هو؟
- رسالة (حب) قديمة تخصني، كان سرًّا، لن تصدقي من كتبها.
- مَن؟
- ستعرفين حين تجدينها، فقط ابحثي عنها.
كان الطريق طويلا، كأنه يسحبُكَ من زمنٍ إلى زمنٍ، في سفرٍ نحو الذاكرة، نحو (أنت) الذي لَم تَكُنه منذ زمن طويل، مرَّ عليكَ سريعًا وغزيرًا وخاليًا من رحلة واحدة صوبَ (مدينتكَ)، تُدرك في عميقِكَ أنك تعود، إلى حيِّكَ القديم، وشُباك بيت جدك الأثير المُطِلِّ على الشارعِ الذي يشبهك جدًا ويفهمك جدًا. الياسمين الذي تفتقده تشمُّه منذ اللحظةِ الأولى للسفر، قبل الوصول وقبل البلوغ. أنتَ تحمِلُ ذاتًا جديدة على كليكما أنت والمدينة القديمة، وتحاول أن تلقيها في أحضانِ وطنك الهَرِمِ الذي هَرِمَ كثيرا في غيابِكَ، وتريد أن تلتمِسَ معذرته، وهو يجلس طاعنًا في الحربِ، ممعنًا في الجدب، متجاهلًا كل اعتذاراتك الكاذبة؛ صعب جدًا أن تصالح العجائز، وهذا وطن عجوز، ويبدو أن بضعة أيامٍ لن تكفي لمصالحته، ولن يدعَكَ (فيما تظن) تشعر بالرَغَد القديم، أو تتذكر باستمتاعٍ وشجن كل التفاصيلِ القديمة، سيصفعك؛ وإن كنتَ مشتاقًا فعليكَ أن تسامحه، وتعطيه خدكَ الآخر لصفعة أخرى، وثالثة ورابعة، حتى تتخلص من ذنبكَ وهجرك.
تستدعي قول أبي الطيب (كلما هزَّنا الشوقُ قلنا، حلب قصدنا وأنتِ السبيل)، لكنه ليس الشوق هذه المرة، بل الخوف من الفقد!!
الطائرة مليئة بمَن يُشبهك مع اختلاف التفاصيل، تشعر بالدفء، رغم أن الجميعَ جالسٌ في مقعده يفكِّر بصمت مُطبق، ولا ينوي أن يخوض أي حوار مع أي إنسانٍ طوال رحلته، لكن شيئا مشتركًا بين المسافرين إلى بلادك يجعلهم متشابهين، ويحاولون التغلب في صمتهم على مشاقِّ الهواجس، واقتلاع أشواك الأسئلةِ المفتوحةِ والاحتمالات العديدةِ التي تنتظرهم في (الحي القديم) ووجوهِ الناس والجيرانِ الذين هاجروا جميعًا، عرضوا بيوتهم (للبيع)، وتركوا العجوزَ غاضبًا جدًا!
وصلتُ أخيرًا، في الحقيقة لم أجد (بيت جدي)، كان بيتًا غريبًا عمَّا عرفنا، رأيتُ سورًا حطمته القذائف المجنونة، وحديقة مهجورة، وأحواض زرعٍ متشققة من اليباس والعطش، أوراق متكومة في الزوايا مثل قصائد غير صالحةٍ للنشر، أرجوحة مكسورة، القلعة التي كانت تحمينا، صارت قلعةٌ من رملٍ أخذت موجة الحرب وجهها الجميل، وتركتها تصارِعُ الغياب!
أقف في الممر القصير الذي سينزل بي إلى القبو، أمسك ضوء كشافٍ قوي، أنزل للأسف على قدمي، حيث لا نوابض للقفز، تهرب العناكب حين يباغتها الضوء، العتمةُ والرطوبة ورائحة الذكريات غزّت أشواكها في عيني، لتسيل عيناي مثل جرحين مالحين، أنا لا أرى شيئًا بوضوح، كأنني أصاب بالعمى.
أحس بيدِ سلام الطفلة تمسك بيدي الباردة، تجرني خلفها، "هيا لنختبئ، أمي تريد أن أكمل صحن الفاصولياء، أنا لا أحب الفاصولياء" ننزل درج السلم وهي تمد يدها إلى مفاتيح النورِ لتشعلها كي تضيء القبو في الأسفل.. لكن الإنارة سرعان ما تفصل مجددًا لنجد أنفسنا في عتمةٍ خانقة.
لكن سلام تعشق القبو، ولطالما اختبأت فيه، لا تهتم أبدًا بالعتمة ولا تخاف من الأشباح وتلعب مع العناكب بكل حبٍّ، لقد كانت النسخة المعكوسة مني، وكانت تجبرني على رفقتها، وتجلس في العتمة تغني لي أغنيات هي من يؤلفها، وكنتُ أكره سخريتها فأكتم خوفي وأبقى معها على قلقٍ "كأن الريح تحتي" بينما تستمتع هي بكل لحظةٍ لنا في القبو.
أصحو من الذكرى وأنا أعُدُّ الدرجات التي أنزلها، لقد أخبرتني سلام أنها تخفي (الرسالة) عند الدرجة الخامسةِ، أضع الكشافَ عند الدرجة الخامسة، أنحني لأزيح البلاطة المكسورة والمنشودة، تهرب عناكب صغيرة، وحشرات زاحفة، فأرتعش من الخوف، أجد كيسًا من القماش، أسحبه من طرفه، أنفضه من أي شيء عالِقٍ به.. أستقيم وأصعد الدرج سريعًا لأخرج من القبو، أشعر أن شيئا ما يلحق بي، إنني أتوهم بلا شك، كأن نوبة الهلعِ تبدأ، أنفاسي تضيق، أصل إلى الطابق الأرضي في الأعلى.. أخرج للحديقة، آخذ أنفاسا متلاحقة طويلة، أخرج قارورة ماء من حقيبتي، أشعر بالنجاة، يقطع الصمتَ صوتُ ابنة أبي محمود: "هل ستغادرين؟".
أنظر إليها ولا أراها، أجيبها بصوتٍ ضعيف: "يمكنكِ إغلاقه الآن".
أخرج للطريق؛ أجلس عند الشجرةِ التي عند رصيف البيت، أنظر للكيس القماشي بيدي وأفتحه، أجد أوراقًا كثيرة مطوية بداخله، أفتح إحداها لأقرأ ما فيها، لكنها فارغة! أين هي الرسالة؟ لا شيء مكتوب فيها!
هل عشتُ كل هذا الخوف من أجل أوراق فارغة، أمسك هاتفي وأتصل بسلام: "سلام، ماذا يوجد في الكيس، هل أوراق فارغة، هل جفَّ الحبرُ أم أكلت العناكبُ الكلمات، ما الذي حدث؟!
تضحك سلام: "هل نزلتِ أخيرًا إلى القبو وحدك"!
أغضب، أكادُ أنفلقُ نصفين، أشعر بالخديعة: "لماذا تضحكين؟"
تقول سلام: "كنت أنتظر اللحظة التي تنزلين فيها إلى القبو وحدك، لقد تأجل هذا المقلب زمنًا طويلا، الآن فقط سأوافق أن يُباع بيت جدي، لقد نلتُ منكِ أخيرًا"
أتعلمين يا سلام، لقد خِفتُ دائمًا من (القبو)، ولكنني اليوم أخيرًا، قتلتُه.
(1) المونة: المؤونة من الثمار والخضار التي يتم حفظها بطرق عديدة لتناولها طوال العام في الفصول التي لا يتوفر فيها.